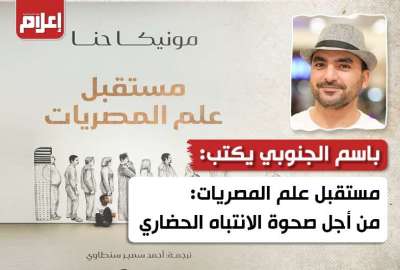باسم الجنوبي يكتب: مستقبل علم المصريات: من أجل صحوة الانتباه الحضاري
على مدار سنوات بقيت كتب التاريخ المصري القديم وما يتعلق به من آخر ما يُقرأ حتى بين أصحاب الشغف بالقراءة والمهتمين بالكتب رغم وجودها وربما اقتنائها، ومع تصاعد الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة وتردد علم المصريات على أسماع الجمهور المصري والعربي بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، دعت الضرورة المعرفية إلى تصفح قوائم كتب الحضارة والتاريخ المصري القديم وعلم المصريات، لنجد أن أغلب المصادر والمراجع وأوائل الكتب ليست لمؤلفين مصريين، ولكن لعلماء آثار وعلماء المصريات الأجانب المرتبطين بالاستعمار الإنجليزي والفرنسي في مصر، كتبوا بوجهة نظرهم الاستعمارية، من هنا تحديدًا تأتي أهمية كتاب "مستقبل علم المصريات" لـدكتورة مونيكا حنا (أستاذ مساعد الآثار والتراث الثقافي، والحائزة على جائزة التميّز الأكاديمي لعام 2025 التي يمنحها الاتحاد العام للآثاريين العرب)، بترجمة أحمد سمير سنطاوي، يُعدّ الكتاب خطوة هامة ودالة في منهجية (إدارة التراث المصري) وهو المشروع الأكبر للكاتبة، تناولت في الكتاب رغم صغر حجمه موضوعات عملاقة وشائكة حان وقتها.
الجزء الأول من الكتاب اشتمل على التعريف بعلم المصريات وأهميته وفروعه وموضوعاته التي يجب دراستها كحقل معرفي حضاري يربط فيه التاريخ الحجر بالبشر ويصل الماضي بالحاضر ويستشرف المستقبل. يتعرض الكتاب كذلك إلى التعريف بقيمة الآثار المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًا وحضاريًا وجزءًا من الهوية، وليست مجرد مقتنيات قديمة يمكن التفريط فيها أو حتى جزءًا منها، ولعل أهم موضوعات الكتاب هي ما لها صلة بعرض جرائم الاستعمار عبر الحملة الفرنسية التي يراها كثير من المستشرقين وحتى عدد من المفكرين المصريين بوابة التحضُر المصري، في حين أنها كانت البوابة الأكبر لسرقة الآثار المصرية، كذلك أشار الكتاب إلى سرقات الاحتلال الإنجليزي للآثار المصرية، و تاريخ سرقات علماء الآثار والمصريات الذين جاءوا عبر بندقية الاحتلال ليحتلوا كذلك مناصب اتخاذ القرار في التنقيب والتهريب للآثار مثل اللورد دوفرين، اللورد فرانسيس جرينفيل، جيمس كويبيل، يوجين جريبوت (أول من أسس غرفة مبيعات للآثار المصرية بقيت تعمل ما يقرب من قرنين)، الغريب أنهم جميعًا كانوا مسؤولين أو قيادات في مصلحة الآثار المصرية بأمر بريطاني أو فرنسي، كذلك.. جيوفاني دا أثاناسي (جامع الآثار الذي كان يعمل لصالح القنصل البريطاني في مصر هنري سولت)، إدوارد نافيل الذي دمرت حفائره ديرًا قبطيًا أثريًا ضخمًا في الدير البحري، كذلك الألماني لودفيج بورشاردت الذي سرق تمثال رأس نفرتيتي بالتواطؤ مع ماسبيرو مدير مصلحة الآثار المصرية وقتها، والذي كان يُشجع التجار وجامعي الآثار على شراء الآثار من مصلحة الآثار نفسها، هوارد كارتر البريطاني الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون وسرق الكثير من مقتنياتها، وعندما استعاد الملك فاروق بعضها سرًا، انتقم كارتر بإزالة كل ملاحظات التنقيب، ليحرم المصريين من القدرة على فهم وإنتاج أي معرفة خاصة بالملك الشاب ومجموعته الأثرية الأكثر إبهارًا في العالم.. هؤلاء من أسسوا لعلم المصريات، ليحققوا النصر الثقافي مع النصر العسكري والسياسي، لإتمام الاحتلال الكامل عبر نسب الحضارة المصرية القديمة إليهم وفي واجهاتها الآثار المصرية والتعريف بها عبر علم المصريات، بالإضافة إلى احتكار هذا العلم عليهم؛ نجد في ثناياه احتقار المصريين العاملين في الآثار، مثل ما حدث من شيطنة أهالي قرية الشيخ عبد القرنة في الأقصر لمدة قرنين من الزمان.
هذه العقلية الاستعمارية في تناول الإرث المصري عبر علم المصريات كان لها أكثر من وجه وجبهة للعمل مثل حصر علم المصريات والعمل الإداري والقيادي في مجال الآثار لمن يرضى عنه المُحتل فقط من الأجانب، وحرمان المصريين والعرب من التعلم والعمل به، وأُصدرت قرارات كثيرة في هذا الشأن من اللورد كرومر شخصيًا وأبلغها لخليفته (السير إدون غورست) بحجة أن المصريين ليسوا متحضرين بما يكفي ليهتموا بالحفاظ على آثارهم، وكررها جاستون ماسبيرو الذي أدار المصلحة العامة للآثار، وهو ما يفسر أن (المصلحة العامة للآثار المصرية) منذ نشأتها في 1835 لم يُدرها مصري إلا عام 1952، رغم أن فكرة نشأتها مصرية بالكامل من يوسف ضياء أفندي والشيخ رفاعة الطهطاوي الذين أقنعوا (محمد علي) بقرار تأسيسها.
تُفسر هذه العقلية الاستعمارية أيضًا إلغاء ترشيح علماء مصريات فرنسيين وأجانب ممن لهم أصول عربية مثل ما حدث مع (ألبرت دانينوس) ذي الأصول الجزائرية بأمر من القنصل الفرنسي، خوفًا من إضعاف سيطرة الفرنسيين على المصريات، نتيجة هذا التهميش يمكن رؤيته بالعين اليوم عبر تأمل واجهة المتحف المصري بميدان التحرير الذي صممه الفرنسي (مارسيل دورغنون) عام 1901، الواجهة تحتفي بالآباء المؤسسين لعلم المصريات دون ذكر لعالم مصري واحد.
تُفسر هذه العقلية كذلك ما قام به المُحتل الإنجليزي من إبادة جماعية لشعب بنين في الغرب الإفريقي (نيجيريا حاليًا) لتوسعة وتسهيل التنقيب والسلب لآثار حضارته الإفريقية، ومصريًا.. تفسر الجرأة في السرقة والنهب والتهريب من المُحتل للآثار المصرية باعتبارها (سرقات مشروعة) بتعبيرالأديب والقاضي أشرف العشماوي الذي أصدر كتابًا قبل سنوات بهذا الاسم، تناول فيه بعض من هذه السرقات، وهنا دكتورة مونيكا تستدعي التاريخ الكامل لهذا النهب منذ (أليساندرو ريشي) طبيب (محمد علي باشا) القادم من إيطاليا، الذي كان يستغل أوقات فراغه لرسم الآثار المنتشرة في طول البلاد وعرضها، إما لحسابه الخاص أو بتكليف من القنصل البريطاني هنري سولت. كذلك سرقات البعثة الفرنسية - التوسكانية عام 1828 التي استقبلها حاكم مصر (غير المصري) ومنحهم الحرية الكاملة لأخذ أي قطع أثرية يريدونها للمتاحف الأوروبية. بالإضافة لما قام به شامبليون ورفيقه عالم المصريات الإيطالي إيبوليتو روزليني في مقبرة سيتي الأول، حيث قاما بقطع اثنين من أجمل أجزاء الموقع بدلًا من الحفاظ عليهما. هذه العقلية الاستعمارية تفسر كذلك الصراع على السطوة والسطو على الأثار المصرية ما بين المحتل الإنجليزي والفرنسي، يلخصه تصريح أحد الصحفيين الفرنسيين في هذه الحقبة بقوله: "إذا كانت مصر الحديثة قد أفلتت من نفوذنا، إلى حد كبير بسبب أخطائنا، فإن مصر القديمة باقية وستبقى فرنسية".
من قصص السرقات الكبيرة والدالّة التي تناولها الكتاب، هي قصة (أوجست مارييت) الذي وصل مصر عام 1850 بتكليف من متحف اللوفر لشراء مخطوطات قبطية، لكن وصوله صادف يقظة قبطية للحفاظ على التراث، فقد أصدر البابا بطرس السابع الجاولي (بطريرك الإسكندرية)، مرسومًا بجمع المخطوطات من الكنائس والأديرة ونقلها إلى القاهرة لحفظها في كاتدرائية الأزبكية، بعد نهب العديد منها أو بيعها لتجار الآثار، ورفض البابا طلبات مارييت المتكررة لشراء المخطوطات، ما دفعه للتنقيب بنفسه على الآثار وتهريبها إلى فرنسا في عهد (الخديو عباس حلمي الأول) الذي غضب منه فتوقف عن الحفر، لكن بعد وفاة عباس حلمي نجح مارييت في إقناع الخديو سعيد بالعفو عنه وقد كان.. وزيادة، عينه سعيد مديرًا لمصلحة الآثار المصرية عام 1858. تم إعطاء مارييت سلطة غير مسبوقة على الآثار المصرية، وسُمح له بالتنقيب عنها بنظام السخرة للمصريين، ما يعني استعباد المصريين باستخدامهم كآلة تنقيب، في نفس الوقت أقنع عالم المصريات الألماني (هاينريش بروجش) الذي كان زميلًا لمارييت في مصلحة الآثار، الخديوي إسماعيل بإنشاء مدرسة اللسان المصري القديم (1867–1874)، ومن هذه المدرسة (التي لم تدم طويلًا) تخرج أحمد كمال باشا (أول عالم مصريات مصري عمل في مصلحة الآثار) ورغم وجود طلاب مصريين كثر بالمدرسة إلا أنهم منعوا من التعليم في المتحف المصري في بولاق بقرار من مارييت نفسه. بالإضافة إلى منع المصريين من تولي أي مناصب إدارية أو عليا في مصلحة الآثار وهو القرار الذي طال أحمد كمال باشا. وطال صدام مارييت علماء مصريين كبار مثل رفاعة الطهطاوي و علي باشا مبارك حرصًا على منع المصريين من إنتاج معرفة تخص ماضيهم، ومع اقتراب نهاية ولايته في مصلحة الآثار عمل على التنقيب سرًا للآثار ودفنها في الصحراء تمهيدًا لتهريبها إلى الخارج.
يقول إدوارد سعيد "الاستعمار لا ينتهي بخروج الجيوش، بل حين يتوقف العقل عن إعادة إنتاج صورته عن ذاته من خلال نظرة الآخر".
وأبعد وأخطر أهداف المُحتلّ ما يتركه خلفه من عقلية تُعيد إنتاجه دون وجوده، هذا ما حدث تمامًا في علم المصريات، فبعد سقوط الإمبراطورية البريطانية وانسحابها من أغلب مستعمراتها وصعود أمريكا كقوة بديلة، جاء المستشرقون الأمريكيون إلى الشرق الأوسط محملين بمفاهيم التفوق الديني والعنصري السائدة في الغرب حينها، وكانوا يكتبون من أبراجهم العاجية عن المواطنين المحليين والأهالي بالنبرة نفسها التي كتبوا بها عن (السكان الأصليين) في أمريكا، وغالبًا ما كانوا يرون مصر من منطلق توراتي ويرفضون التفاعل مع الإسلام والعالم العربي، لذلك كتبوا عن الآثار المصرية باعتبارها جزءًا من (التراث العالمي)، وهو تصور يرى أن الآثار لا تنتمي إلى شعوب الدول المحلية، بل تنتمي إلى البشرية جمعاء، بغض النظر عن مكان وجودها، وغالبًا ما كان معنى البشرية في تصورهم محصورًا على ذوي البشرة البيضاء، إنه التمويه والسلب، نفس الأسلوب الذي استخدمه الاحتلال الإسرائيلي مع التراث الفلسطيني، حيث سرق مئات الآلاف من الكتب التراثية من أروقة الجامعات والمكتبات العامة والخاصة الفلسطينية على مدارعقود وأدراجها بالمكتبة الوطنية الإسرائيلية في القدس تحت اسم (AP) ما يعني أنها ممتلكات متروكة أصبحت ملكًا للجميع، والجميع هنا بالطبع هو الاحتلال نفسه.
في تاريخ علم المصريات نجد المثال الأوضح على ذلك الأمريكي (جيمس هنري بريستيد)؛ صاحب كتاب (فجر الضمير) وأول عالم مصريات حاصل على تدريب أكاديمي في الولايات المتحدة، كان مشبعًا بهذه الأفكار، حيث تجسدت تصوراته في الجدارية التي صممها لتعلو مدخل المعهد الشرقي الذي أنشأه في جامعة شيكاغو؛ تصور ملوك مصر وبابل وآشور ينقلون علومهم وفنونهم إلى اليونان والرومان وعلماء آثار أوروبيين وأحد الفرسان الصليبيين، مع محو كامل للعرب والمسلمين والمصريين المعاصرين. بريستيد كان يردد كثيرًا أن علم المصريات الغربي سيتضرر إذا سُمِح للمصريين بدراسته في الجامعات العربية، وكان يُقلل من قيمة أي عربي يتعلم في الخارج ويرفض تعيين المصريين في مصلحة الآثار، ولعل عبارته الشهيرة دالة على مجمل فكره في هذا الشأن "حفظ الله مصر من المصريين".
مشهد آخر في غاية الخطورة يوضح هذه النفسية، عندما أرسلت مصلحة الآثار المصرية تقريرًا عاجلًا كنداء استغاثة يطلب من العالم المساعدة لإنقاذ آثار النوبة من الغرق في يونيو 1955، جاءت الاستجابة الوحيدة من متحف المتروبوليتان في أمريكا، لم يكن عرضًا للمساعدة؛ لكن طلبًا لشراء معبد أو اثنين من معابد النوبة.
الجزء الثاني من الكتاب يتناول كيف تطورت العلوم المادية والإنسانية والنظريات الاجتماعية، بينما تخلف علم المصريات عن الركب، رغم تقدم مجال دراسة علم الآثار، رغم كون جذور وأصول علم المصريات أبعد، فقد كتب المصريون القدماء عن أنفسهم عبر جدران وأسقف المعابد والمدافن والبرديات، وكتب عنهم اليونانيون والرومان مثل هوميروس وهيرودوت ومانيتون، وكتب عنهم العرب وعلماء المسلمين مثل المقريزي والسيوطي وذي النون والبغدادي، وبعد أن جاءت المدرسة الفرنسية في علم المصريات (ركزت على الفن والدين) والمدرسة الألمانية (ركزت على اللغة) والمدرسة البريطانية (ركزت على الثقافة المادية)، والمدرسة الإيطالية (ركزت على التاريخ اليوناني الروماني بمصر)، والمدرسة الأمريكية (دراسة التاريخ بعين ما بعد الحداثة)، كل هذه المدارس ربطت العلوم المادية والإنسانية بما فيها الاجتماع والفلسفة بدراسة علم الآثار بينما نسوا أو تناسوا ذلك في علم المصريات. الأمر الذي جعل (خوان كارلوس جارسيا) يُطلق على علم المصريات "التخصص الملعون"، متحسرًا على اللامبالاة التي اتسم بها علماء المصريات، واستكانتهم للحفاظ على هذا المجال كتخصص غرائبي، متوقفًا عند فلسفة كارتر أن هذه الآثار مجرد "أشياء رائعة"، لتتناوله تباعًا وسائل الإعلام كمصدر للترفيه والتضليل عن الحاضر الكئيب.
تعرض الكتاب كذلك إلى جوانب من إقصاء علماء المصريات المصريين البارعين مثل لبيب حبشي، سليم حسن، أحمد كمال باشا، بل لم يكتف الأجنبي بإقصائهم عن المناصب والإدارة الأثرية، لكن أيضًا تم سرقتهم أدبيًا بشكل صارخ عبر عدم الاعتراف بأهليتهم، وسرقة نتائج عملهم مثل ما حدث مع لبيب حبشي الذي سرق اكتشافاته عالم المصريات البلجيكي (كونستانت دي ويت) في جزيرة الفنتين وقبة الهوا في أسوان ونسبها لنفسه بكل وقاحة في مؤتمر دولي للمستشرقين بفرنسا.
"ألم تستقل البلاد؟! لكن كونوا على يقين أنهم سيديرون شؤوننا من بعيد، هذا لأنهم تركوا وراءهم من يفكرون مثلهم".
كلمات الأديب السوداني الطيب صالح، أنسب ما يمكن أن نصف به علم المصريات حاليًا، منذ نشأته في الحقبة الاستعمارية وحتى ما بعد الاستعمار، ببساطة لأن إنتاجه بقي حكرًا على المستعمر وأحفاده إلى اليوم، وحتى كثير من الكتابات المصرية القديمة والجديدة بقيت حبيسة للسردية الاستعمارية، فيما تُمارس أساليب الحجب والاتهام وعدم الدعم للجهود المصرية الجادة في إنتاج سردية حضارية مختلفة عن سردية الرجل الأبيض.
وهنا يُحرض الكتاب على دراسة وتحليل الإرث الاستعماري وتأثيراته السياسية والثقافية والاجتماعية المستمرة في الدول والشعوب المستعمَرة بعد رحيل الاستعمار بشكل رسمي، ببساطة لأن الفكر والحكم الاستعماري يتم إنتاجه من خلال الأنظمة والحكومات المحلية حتى بعد جلاء ورحيل الاستعمار بسنين عديدة، وهذه هي الورطة الأكبر في علم المصريات الذي يجب أن يكون واقعه كما اسمه، علم فهم مصر القديمة من خلال دراسة نشأتها وتطورها وأنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومعتقداتها الدينية وأساطيرها، وكيف شكلت هذه العوامل فنها وعمارتها كشكل من أشكال الثقافة المادية. ما يجعله أسمى من أن يتحول إلى استعراضات شعبوية مختلطة بالعلوم الزائفة؛ بهدف جذب السياحة الغربية، وهو مع الأسف ما حدث قبل سنوات، حيث شهدت الحفائر الأخيرة في سقارة، استخدام البلدوزر في التنقيب لتزيل في طريقها طبقات تاريخية، وعرض الاكتشافات الأثرية للجمهور دون توعية كافية بماهيتها وأهميتها، وفي مناطق أخرى مُحِيَت الطبقات التاريخية من العصور الوسطى والحديثة، لإنشاء فراغ أثري مُتخيَّل، وأبرز مثال على ذلك تدمير الطبقات التاريخية حول طريق الكباش، هذه الممارسات تدمر آثار المواقع وتاريخها، وتعيد علم المصريات إلى عصور المغامرين وتجار الآثار في القرن التاسع عشر.
الجزء الثالث من الكتاب يتناول مستقبل علم المصريات من خلال ثلاثة محاور رئيسة؛ وهي الوضع الراهن في إنتاج الأبحاث، ثم تمثيله في الثقافة الشعبية، ثم التصورات والآمال عن مستقبله. هذه التحديات تستتبع بحسب الخبراء، النشر الأكاديمي المصري الملائم للحفائر بدلًا من احتكارها لصالح قلة مُختارة غالبًا ما تكون منحازة لأجنداتها الأيديولوجية، إيجاد حلول عاجلة للقيود المالية، رفع الوعي الأثري للجمهور دراسيًا وإعلاميًا، إعادة النظر في دخول غير المتخصصين إلى المجال، دعم البعثات المصرية للتنقيب عن الآثار بدلًا من البعثات الأجنبية، تحقيق عدالة التمثيل والحاجة إلى تمكين الخبرات المحلية وإعادة تقييم طريقة دمج الاكتشافات الجديدة في التراكم المعرفي لعلم المصريات، التوعية بالتأثير عميق الجذور لمصر القديمة على سلوكيات المصريين ولغتهم وتقاليدهم، تسهيل الوصول إلى المعرفة في مجال علم المصريات، وعلى رأسها الحصول على المنشورات والمصادر العلمية المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة، دمج السكان المحليين في العمل الأثري، استمرار الكتابة النقدية لعلم المصريات لإنهاء الاستعمار من السرديات التاريخية به لبناء مستقبله الوطني.
نرشح لك: "عمرو .. حيث هناك وحده": قصة حياة عمرو دياب أحدث روايات إبراهيم عيسى
وبعد: الكتاب لا يهاجم ولا يرفض علم المصريات لكنه يحاول تفكيك هذا العلم ومعالجة ما اعترى تراثه من سلبيات عبر تحليل نظرياته وممارساته الحالية، وتقديم سردية تفكيكية لتاريخ هذا العلم الذي ابتكره الأوروبيون لصالحهم، والتركيز بشكل دقيق على اقتناء (الكنوز) للمتاحف وإبقاء التخصص حبيس أبراج عاجية يركز على الآثار المصرية لا المصريين.
هذا التفكيك خاصة من خلال الوثائق المحفوظة في دار الوثائق المصرية، يستكشف بسهولة الأجندة الاستعمارية التي شكلت هذا العلم على مدار قرنين، يهدف الكتاب كذلك إلى تقديم أفكار لتطوير علم المصريات عبر إعادة إنتاجه من وجهة نظر حضارية مصرية لا تستبعد أهلها ويكرس للأهلية الاجتماعية وقدرة الأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة المصرية على التصرف والتأثير بشكل فعال في هذا المجال، ويبرز دورهم في تشكيل ثقافاتهم وتاريخهم. يقول ابن خلدون: "الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء". والوعي بالماضي كما كان لا كما يصوره الغريب أدعى بحاضر أقدر ومستقبل لا يكرر أخطاء سابقة، بذلك يكون "مستقبل علم المصريات" كتاب حان وقته لصحوة وتصحيح الانتباه الحضاري حتى لا تتم المحاولة القديمة والمستمرة في سرقة إرث واحدة من أقدم حضارات العالم ومستقبلها.