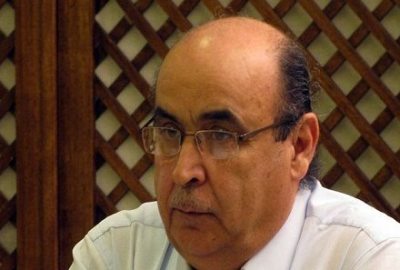نصري الصايغ: صراع بين حرية التعبير وصيانة المقدس
اهتزت فرنسا ولم تقع. خافت ولم تهرب. ضربها الإرهاب ولم تُهزم، قاومته ولم تنتصر عليه: الأيام المقبلة تحمل نُذر حروب متقطعة في عقر عظمتها. لا طمأنينة بعد، فالإرهاب ينتشر ويتوالد بسرعة الكترونية، ويعبر الكيانات والأوطان والقارات. ومعاركه تقاس بمقدار الرعب الذي يثيره.
فرنسا إذاً، ساحة حرب، وتتعدد الأسباب، من رسوم «شارلي إيبدو» إلى مشاركة «التحالف الدولي» في قصف «داعش»، إلى الحرب في مالي، إلى التراخي في مراقبة ومتابعة حركة العبور من فرنسا إلى مواقع «داعش»، في المشرق، وأفواج الحجيج إلى قواعد «القاعدة» في اليمن، وأنى تيسّر ذلك أيضاً. تعددت الأسباب والجواب: إنه الإرهاب بأذرعه المتعددة.
الإرهاب، بصيغته الدينية الجديدة، غير مسبوق: لم تعرف أميركا قبل «11 سبتمبر» مثيلاً له، ولا عرفت فرنسا في تاريخها مثل هذا الجنون المتقن والمنظم والرهيب. أصيبت فرنسا كلها، فالتأمت في وقفة وطنية غير مسبوقة، تجاوزت خلافاتها وصراعاتها وعنعناتها، ففاضت شوارعها وساحاتها في المدن كلها، بشعب يعبّر عن انتمائه إلى أمته وقيمه وحريته وديموقراطيته. واستجاب العالم للتحدي، فتحوّلت باريس إلى عاصمة عالمية في مواجهة خطر الإرهاب، وإلى دينامو يحرض على اتخاذ قرارات عملية لخوض المعركة.
هل هذا كافٍ؟
هذا أقل الإيمان، ولكن، ربما فات الأوان، فالإرهاب مستوطن في أمكنة كثيرة، وكأنه دائماً خلف كل باب. لم يعد نائياً وبعيداً. ودلت الاستقصاءات الأولية في فرنسا أن على الإرهابيين الثلاثة لم يهاجروا إليها بل كانوا فيها ومنها.
ثلاثة أيام قاصمة للأمة وشعبها، فتحت الأسئلة على المجهول المخيف، أبرزها: مستقبل الإرهاب في أوروبا. كأن فائض الإرهاب القادم غداً من العراق والشام وليبيا وتونس والجزائر واليمن ودول النفط العربية وسواها، سيجد طريقه إلى قلب الغرب في أوروبا. من حق أوروبا أن تخاف.
بعد نهاية المشهد الدولي، انصرفت باريس إلى أسئلتها: لماذا حصل ذلك؟ أين الخطأ الفادح؟ كيف لم تتنبه الأجهزة إلى سجل الإرهابيين الحافل بالنقاط المثيرة للخوف والتوجس؟ أسئلة يجيب عنها القضاء ولجان برلمانية للتحقيق، واقتراحات لمشاريع قوانين، تتشدد في المراقبة، من دون الوقوع في فخ تقييد الحريات.
أفدح الأسئلة كان: كيف تحافظ فرنسا على الوحدة عملياً؟ فالمسلمون الفرنسيون يعيشون خوف التعرض للانتقام، واليهود الفرنسيون يطالبون بالحماية الأمنية لمدارسهم ومؤسساتهم من دون تشكل قناعة كافية بإمكانية العيش في غير إسرائيل.
أكثر الأسئلة حراجة: كيف التوفيق بين العلمانية والإسلام، بين حرية التعبير المقدسة وحرية الاعتقاد بالمقدس (الله والرسل والدين) في مجتمع واحد؟ لقد رفضت أكثر من 65 مؤسسة تربوية رسمية الامتثال لدقيقة صمت حداداً على ضحايا «شارل إيبدو». استعاضت الإدارات عن دقيقة الصمت بحلقات نقاش وتفكير وتوضيح. لم تكن المهمة سهلة: احترام حرية التعبير مقابل حرية الاعتقاد بالمقدس وعدم تدنيسه بحجة الحرية.
لا خلاصات لهذا النقاش المفتوح. العلمانية في فرنسا انتصرت على الكنيسة الكاثوليكية، ولم يكن في فرنسا مسلمون وإسلام. هُزمت الكنيسة وأُخرجت برمّتها من السياسة ومُنع رجال الدين من التعاطي، وحُرِّم على الدولة دعم المؤسسات الدينية ورجال الدين. ما العمل مع إسلام وفد إليها مع اندلاع ثورة التصنيع والحاجة إلى يد عاملة تضمنها المستعمرات في سوق عمل مرهق ومجحف ومؤذ للكرامة الإنسانية؟ خلاصة قرن من الهجرة والإقامة والتجنيس أفضت إلى حضور إسلامي وافد وموطّن في فرنسا العلمانية. لم يشكل في البدء مشكلة للسلطة والمجتمع، حيث الوافدون المقيمون، مواطنون دونيون، مطلبهم العيش بالحد الأدنى من الخبز والحد الأدنى من الحاجة إلى التعبير العلني والمشروع عن إيمانهم وفروضه.
يقظة المسلمين في فرنسا جديدة. هي نتاج عقود من النبذ والإقصاء والحرمان، وخلاصة فشل تجربة الاندماج الصعب، الذي لم توفر له التقاليد الفرنسية الاستعلائية، الشروط الملائمة، لتحقيق المواطنة بشروط المساواة في الحقوق والواجبات. وساعد هذه اليقظة المتأخرة عن الظهور، بروز تيارات وحركات إسلامية وسياسية في المشرق العربي، رسمت معالم شخصية إسلامية لها حضورها في الثقافة والمسلك وفي تبني قضايا كبرى، بقراءة دينية خالصة، مدعمة بعقيدة ومال وفرته الثروة النفطية المتدفقة من بعض دول الخليج العربي وضفاف الفارسي.
أبرز التيارات الإسلامية في المشرق كان إما بصيغة وهابية إخوانية، وإما بصيغة الثورة الإيرانية. منح هذا البروز للإسلام السياسي المسلمين في فرنسا منعة لإثبات الهوية الإسلامية وإشهارها، والعمل على ترجمتها في ميادين الحياة الاجتماعية المشبعة أساساً بالعلمانية، وهذا ما أدى إلى تشنج العلاقات وازدياد التفاوت وممارسة التمييز بأشكاله كافة.
ما كان في حالة كمون بات في حالة تمرد، عبّرت عنه انتفاضات الضواحي المهملة والمرذولة والمكتظة بالشباب المحبط والمنكود، العاطل من العمل والمضطر إلى مخالفة القانون، والتعرض بسبب ذلك للعقوبة والتشهير.
أضيف إلى ذلك إرث السياسات المنحازة لإسرائيل، ومعاداة الثورات العربية والنضالات الفلسطينية. فرنسا مثقلة بإرث دعم البربرية الإسرائيلية، باستثناء حقبة قصيرة من عمر الديغولية في السلطة، إبان عدوان حزيران 1967.
غذت الأحداث والانقلابات والحركات الإسلامية، المسلمين في أوروبا، بزاد افتقده الروّاد الأوائل الذين استقدموا من «المستعمرات» الناطقة بالعربية والمدينة بالإسلام، ليكونوا «عبيداً» للآلة، وخدماً في نظام رأسمالي طاحن. وصدف أن انتماء هؤلاء قد وجد حضنه الطبيعي في الحركات القومية والأنظمة «التقدمية» والتي كانت على نقيض الحركات الإسلامية (الناصرية في مصر، العلمانية في تونس، الاشتراكية في الجزائر، القومية في سوريا والعراق). كان انتماء المسلمين في الغرب يجد تعبيراته في تبني قضايا البلاد التي قدموا منها، وقد كانت بلاداً ضحية استعمار مباشر، وحروب مختلفة بشتى الطرق.
اليقظة الإسلامية أوجدت تحدياً للمسلمين وللبيئات التي يشتركون فيها مع سواهم من المواطنين الملتزمين بالعلمانية المتطرفة.
وهو ما أحدث أكثر من سوء تفاهم وأقل من «حرب أهلية»، تخشاها فرنسا، بعد مذبحة «شارل إيبدو» والتي وجدت إرهاصاتها في الاعتداءات على دور عبادة المسلمين وبعض مؤسساتهم، وفي الخوف المتبادل من انزلاق الوضع إلى بؤر فتنوية متنقلة. هذا التخوف، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الطلب من وسائل الإعلام كافة، عدم التعرض للإسلام والإسلاميين والامتناع عن ذلك، حفاظاً على «الوحدة الوطنية» وخوفاً مما لا تُحمد عقباه، خصوصاً أن «الحرب على غزة» قسّمت المجتمع الفرنسي طائفياً، فاعتبر غلاة العنصريين أن تأييد «حماس» هو لا سامية جديدة.
الاستثناء لما جاء أعلاه يمكن ملاحظته من خلال اندماج أكثرية إسلامية بالمجتمع، واعتبار الدين شأناً روحياً والمجتمع شأناً علمانياً. أغلبية المسلمين في فرنسا، فرنسيون أولاً وأخيراً، ويتعاطون مع قضايا وطنهم بفروض المواطنة، وليس بـ «قبليات» الفروض الدينية. ولأن هؤلاء كذلك، ولأنهم يعتبرون أنفسهم كائنات طبيعية في مجتمع طبيعي، فلا مشكلة لديهم، ودورهم داخل «المجتمعات الأم» ضئيل أو غير موجود بالمرة. المشكلة إذاً مع أقلية: داخل مجموعة تعدادها عشر سكان فرنسا. المندمجون هم فرنسيون أولاً. الإسلاميون، هم مسلمون أولاً. والفرق شاسع بين الاثنين.
ما العمل؟ فرنسا على مفترق غير مسبوق. ما تم كتمانه في الأيام الأولى بعد مذبحة «شارل إيبدو» وجد طريقه إلى العلن، في نقاش مفتوح ومأزوم.
ما العمل؟ علمنة الإسلام والمسلمين أم الاعتراف بالاختلاف والقبول بالتعدد والخصوصية الدينية، ما تعتبره الثقافة السياسية الفرنسية والغربية السائدة، تمزيقاً للمجال العام وتهديداً لوحدة الأمة ووحدة التشريع؟
بعض الذين شاركوا في نقاشات الأيام الماضية اقترح فتح نقاش واسع ومسؤول حول هذه المسألة من دون تربص وأحكام مسبقة وإدانات جاهزة، لدين يختلف نصه وتاريخه عن المسيحية. الإسلام في منشئه وأوطانه لم يتعلمن بعد، وقد تستحيل العلمنة أو تتأخر جداً، فكيف التعاطي مع جماعة مأزومة وتزداد ابتعاداً عن السائد لدى أكثرية الفرنسيين؟
المسألة ليست سهلة ولكنها داهمة، ربما يكون فات الأوان!
في عودة إلى البداية، فإن فرنسا ملزمة بأخذ الأمثولة: الإرهاب لم يعد محلياً. إنه منتشر ومدمر، وحصة كل دولة جاهزة. التساهل معه جريمة. التغاضي عنه أو توظيفه كارثة. ما ولُد أو استُولد إرهاب حتى ارتد على من أوجده وغذاه. ما يحصل من بربرية في المشرق وليبيا واليمن، هو مسؤولية مشتركة. تسليح «الربيع العربي» في ليبيا، أيقظ الوحش الديني في ليبيا وسوريا والعراق وهلم جراً. الجمرة تكوي كل المطارح لا مطرحها فقط.
ماذا بعد؟
ملف البربرية كبير. ما تعرضت له باريس، وهو مريع وعميق التأثير، هو نقطة في بحر ما نتعرض له نحن. نحن ضحايا مثلت الإرهاب. حصتنا من البربرية تدمير أمة وتفجير شعوب وتفتيت مجتمعات وسبي المستقبل بأضغاث الماضي. حصتنا من البربرية، حروب إسرائيلية مدمرة وظالمة ومتوحشة ولا تمتلك أدنى حق ولا تمت إلى مبدأ، ومع ذلك، فهي في نظر فرنسا وكثير من الغرب، حرب الملائكة الحضاريين ضد الوحوش والهمج من العرب والمسلمين والفلسطينيين. حصتنا من البربرية حروب متتالية من قبل الولايات المتحدة الأميركية ومن معها (العراق نموذج لمذبحة القرن، حصاراً وتدميراً وتمزيقا وقتلا وتفتيتا). حصتنا من البربرية أنظمة استبداد، ملكية وجمهورية لا تعتبر أنها تحكم شعوباً، بل عبيداً. ولهذا كلام آخر، في مقام آخر.
نقلًا عن “السفير”